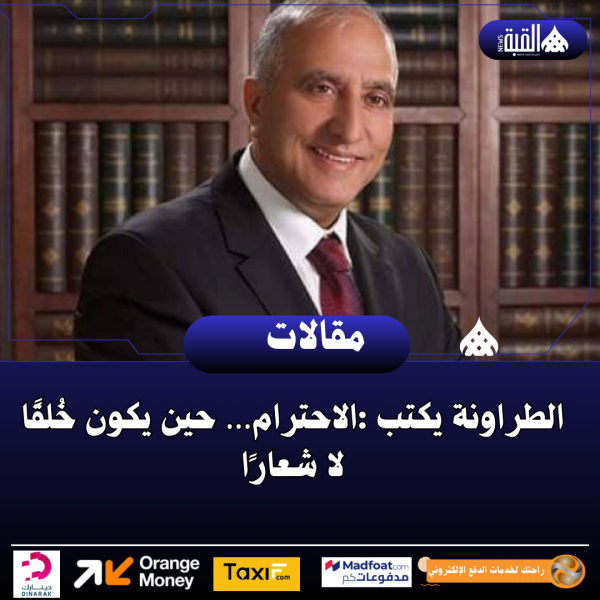العيد فقد بساطته..!

علاء الدين أبو زينه
القبة نيوز- الكثير من الأشياء فقدت بساطتها في النصف قرن تقريباً الذي يمكنني أن أتحدث عنه. بل إن حياتنا كلها، بيومياتها ومعناها ومطالبها، ذهبت دائماً إلى الاكتظاظ والتعقيد كل الوقت وبلا هوادة. ولا بد أن يقع «العيد» هو الآخر ضحية لهذه الحركة في اتجاه ضبابية المعنى وارتباك التفاعلات.
عيد الفطر وعيد الأضحى في الأساس احتفالان دينيان، يؤشران على الانتهاء من أداء فريضتي الصيام والحج، على التوالي. وينبغي أن يكون معناهما مرتبطاً بالنجاح في أداء هذه العبادات. لكن مظاهر الاحتفال لم ترتبط بالضرورة بالذين أدوا العبادات بالضبط، خاصة وأن الأطفال هم الأكثر انتظاراً للعيد. وقد أصبح العيد ممارسة ثقافية وجزءاً من طريقة الحياة. فإذا جاء العيد، سيشارك الجميع فيه كمناسبة لكسر الرتابة والتواصل مع الأقارب والجيران للتهنئة – ربما بالعيش سنة أخرى، والتعبير عن المودة.
من حيث المبدأ، ربما تكون طقوس العيد – العطلة، والملابس، والزيارات- هي هي، لكنّ المتطلبات النفسية والاجتماعية والمادية لأداء هذه الطقوس هي التي تغيرت. نفسياً واجتماعياً ولوجستياً، أدى ذهاب الناس إلى مزيد من الفردانية والانفصال إلى تقليل الرغبة في التواصل مع عدد كبير من الناس في وقت قصير وربما بلا اختيار. كان الأقارب في السابق يسكنون في القرية الواحدة أو الحي الواحد، ولم يكن التواصل معهم في العيد خروجاً كبيراً عن مألوف الالتقاء بهم ومعرفة أحوالهم، وكذلك كان حال الجيران في الحي، الذين يعرفون الكثير عن بعضهم بعضاً ويتزاورون ويتفاعلون بلا توقف.
الآن، نادراً ما يلتقي أهل البلد في المدن الكبيرة، ويسكنون غالباً في أماكن متباعدة، ولا يكادون يعرفون شيئاً عن بعضهم بعضا إلا بالصدفة. وفي الحيّ المدني، يغلب ألا يعرف المرء جيرانه في البناية الواحدة، باستثناء التحيات المقتضبة عند المصعد أو في مرآب السيارات. وعندما يحاول المرء أداء "واجب” زيارة الأقارب والجيران، فإنه ربما يشعر بأنه يزور غرباء تقريباً –حرفياً- وسيكون عليه أن يتدبر أمر بدء حديث والاعتذار عن غياب سنة. ويغلب أن تكون جولة الزيارات من نوع «الواجب الثقيل» الذي يود المرء أن ينتهي منه فحسب.
ومن ناحية الكلفة المالية للعيد، لم يعد تحمل كلفة ملابس جديدة للأولاد و»عيديات» القريبات والأطفال المستحقين لهذه الهبات متاحاً للأغلبية. لقد أدركها بالتأكيد «غلاء المعيشة»، فزادت قيمة المطلوب كثيراً بينما لم تتحسّن الدخول في نفس الفترة بما يقترب من تناسُب معقول. الآن، سوف يحتاج المرء إلى أن يملأ جيوبه بمئات الدنانير إذا ما أراد أداء «الواجب» كما ينبغي، وسيوزعها في ساعات ويعود خالي الوفاض. ولن تكون العيدية القليلة مناسبة للـ”بريستيج” وستكون محرجة بالتأكيد. لذلك، تختصَر قائمة القريبات المستحقات للعيديات إلى القرابة من الدرجة الأولى، ويغلب أن يكون حتى هذا عبئاً مالياً ونفسياً.
بطبيعة الحال، خضع العيد لسيادة نمط الاستهلاك والفرز الطبقي اللذين نجما عن "طفرة النفط” التي غيرت العالم العربي وعاداته منذ النصف الثاني من القرن الماضي تقريباً. وأصبح العيد أكثر ارتباطاً بالتظاهر الاجتماعي ومجاراة الآخرين، حتى عندما لا تتوفر الإمكانيات، حيث عدم القدرة لا يعفي صاحبه من الشعور بالحرج أو تعذيب نفسه للوفاء بالمتطلب الاجتماعي القاهر. وأصبح الشعور بـ»الواجب» المترسخ عميقاً في بنائنا الثقافي يعزز شعوراً بالتقصير والذنب والخجل لدى العجز عن أدائه.
وللأطفال، لم يعد العيد تلك الملابس التي يغلب أن تكون بسيطة ورخيصة، و»فرد فلين» أو ركوب الأراجيح وقروش من العيديات. بل إن ما هو أكثر بكثير من ذلك لم يعد يشيع نفس الفرح القديم الخاص في الأعياد عندما كنا أطفالاً. ويبدو أن ثمة مناخاً مناهضاً للفرح يؤثر على الجميع، ربما يكون مصدره عدوى المشاعر «السلبية» التي تنتقل من الكبار إلى الصغار في الهواء. في السابق، حتى الفقراء كان لهم عيد متعاطف مع أحوالهم البسيطة. أما الآن، فلم يعد العيد، بمعنى السعادة بالصحبة والكسر الإيجابي للرتابة، قريب المنال. أصبح حجم الهول الذي سادراً وغالِباً بحيث يطوي في ظلاله أي أفراح ممكنة بسيطة.
وفي الأعياد الأخيرة، جاء «كورونا» ليتعارض جذرياً مع العيد: لا تواصل، ولا نقود للملابس ولا العيديات، ولا نفسيّة لعمل شيء. ربما كان العيد هو مجرد النجاة. ولذلك، لكل الذين نجوا بصحتهم وخبزهم، والذين يعانون، عسى أن تعود عليكم الأعياد وأنتم بخير.